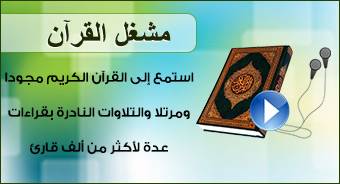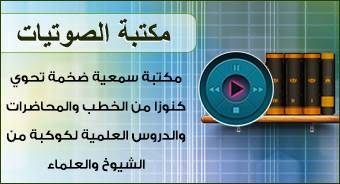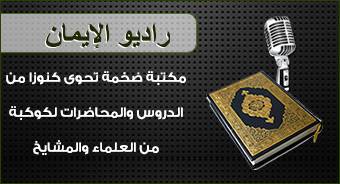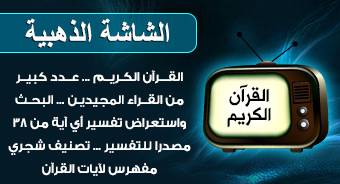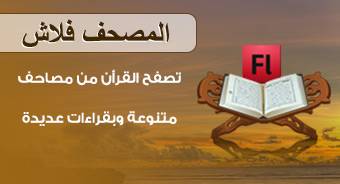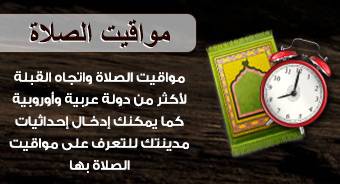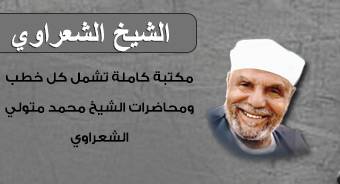|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقال أبو علي وغيره: إظهارُ أبي عمرو {اللايْ يَئسْنَ} يدلُّ على أنه يُسَهّلُ ولم يُبْدلْ وهذا غيرُ لازم؛ لأنَّ البدلَ عارضٌ. فلذلك لم يُدْغمْ. وقرآ- هما أيضًا- وورشٌ بهمزةٍ مُسَهَّلة بينَ بينَ. وهذا الذي زعم بعضُهم أنه لم يَصحَّ عنهم غيرُه وهو تخفيفٌ قياسيٌّ، وإذا وقفوا سكَّنوا الهمزةَ، ومتى سَكَّنوها استحالَ تسهيلُها بينَ بينَ لزوال حركتها فتُقْلَبُ ياءً لوقوعها ساكنةً بعد كسرةٍ، وليس منْ مذهبهم تخفيفُها فتُقَرَّ همزةً.وقرأ قنبل وورشٌ بهمزةٍ مكسورةٍ دونَ ياءٍ، حَذَفا الياءَ واجتَزَآ عنها بالكسرة. وهذا الخلافُ بعينه جارٍ في المجادلة أيضًا والطلاق.قوله: {تُظاهرون} قرأ عاصمٌ {تُظاهرون} بضم التاء وكسر الهاء بعد ألفٍ، مضارعَ ظاهَرَ. وابنُ عامرٍ {تَظَّاهرون} بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء مضارعَ تَظاهَر. والأصل {تتظاهرون} بتاءَيْن فأدغم. والأخوان كذلك، إلاَّ أنهما خَفَّفا الظاءَ. والأصل أيضًا بتاءَيْن. إلاَّ أنهما حَذَفا إحداهما، وهما طريقان في تخفيف هذا النحو: إمَّا الإدغامُ، وإمَّا الحَذْفُ. وقد تقدَّم تحقيقُه في نحو: {يَذَّكَّرْ} و{تَذَكَّرُون} مثقلًا ومخففًا. وتقدَّم نحوُه في البقرة أيضًا.والباقون {تَظَّهَّرون} بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء والهاء دونَ ألفٍ. والأصل: تَتَظَهَّرُوْن بتاءَيْن فأدغَم نحو: {تَذَكَّرون}. وقرأ الجميع في المجادلة كقراءتهم هنا في قوله: {يُظَاهرُونَ من نّسَآئهمْ} [المجادلة: 3] إلاَّ الأخَوَيْن، فإنَّهما خالَفا أصلهما هنا فقرآ في المجادلة بتشديد الظاء كقراءة ابن عامر. والظّهارُ مشتقٌّ من الظَّهْر. وأصلُه أن يقولَ الرجلُ لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وإنما لم يَقْرأ الأخَوان بالتخفيف في المجادلة لعدم المسوّغ له وهو الحذفُ؛ لأنَّ الحذفَ إنما كان لاجتماع مثْلَيْن وهما التاءان، وفي المجادلة ياءٌ من تحتُ وتاءٌ من فوقُ، فلم يجتمعْ مثْلان فلا حَذْفَ، فاضْطُرَّ إلى الإدغام.هذا ما قُرئ به متواترًا.وقرأ ابنُ وثَّاب {تُظْهرُون} بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء مضارعَ أَظْهَرَ. وعنه أيضًا {تَظَهَّرُون} بفتح التاء والظاء مخففةً، وتشديد الهاء، والأصل: تَتَظَهَّرون، مضارعَ تَظَهَّر مشددًا فحذف إحدى التاءين. وقرأ الحسن {تُظَهّرون} بضمّ التاء وفتح الظاء مخففةً وتشديد الهاء مكسورةً مضارعَ ظَهَّر مشددًا. وعن أبي عمروٍ {تَظْهَرُون} بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارعَ ظهر مخففًا. وقرأ أُبَي- وهي في مصحفه كذلك- تَتَظَهَّرون بتاءَيْن. فهذه تسعُ قراءات: أربعٌ متواترةٌ، وخمسٌ شاذةٌ. وأَخْذُ هذه الأفعال منْ لفظ الظَّهْر كأَخْذ لَبَّى من التَّلْبية، وتأَفَّفَ منْ أُفٍّ. وإنما عُدّي ب من لأنه ضُمّن معنى التباعد. كأنه قيل: يتباعَدُون منْ نسائهم بسبب الظّهار كما تقدَّم في تعدية الإيلاء ب من في البقرة.قوله: {ذلكمْ قولُكم} مبتدأٌ وخبرٌ أي: دعاؤكُم الأدعياءَ أبناءً مجردُ قول لسانٍ منْ غير حقيقةٍ. والأَدْعياءُ: جمعُ دَعيّ بمعنى مَدْعُوّ فَعيل بمعنى مَفْعول. وأصلُه دَعيْوٌ فأُدْغم ولكن جَمْعَه على أَدْعياء غيرُ مَقيس؛ لأنَّ أَفْعلاء إنما يكونُ جمعًا لفَعيل المعتلّ اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو: تقيّ وأَتْقياء، وغَنيّ وأغنياء، وهذا وإنْ كان فَعيلًا معتلَّ اللام إلاَّ أنه بمعنى مَفْعول، فكان قياسُ جمعه على فَعْلَى كقتيل وقَتْلَى وجريح وجَرْحى. ونظيرُ هذا في الشذوذ قولُهم: أَسير وأُسَراء، والقياس أَسْرَى، وقد سُمع فيه الأصل.{ادْعُوهُمْ لآبَائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عنْدَ اللَّه}.قوله: {هُوَ أَقْسَطُ} أي: دعاؤُهم لآبائهم، فأضمرَ المصدرَ لدلالة فعله عليه كقوله: {اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة: 8].قوله: {ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ} يجوزُ في ما وجهان، أحدُهما: أنها مجرورةُ المحلّ عطفًا على ما قبلها المجرورة بفي، والتقديرُ: ولكنَّ الجُناحَ فيما تعمَّدت. والثاني: أنها مرفوعةُ المحلّ بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ. تقديرُه: تُؤَاخَذُون به، أو عليكم فيه الجُناحُ. ونحوُه.{النَّبيُّ أَوْلَى بالْمُؤْمنينَ منْ أَنْفُسهمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}.قوله: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} أي: مثلُ أمّهاتهم في الحكم. ويجوزُ أن يُتناسى التشبيهُ، ويُجْعلون أمَّهاتهم مبالغةً.قوله: {بعضُهم} يجوز فيه وجهان، أحدُهما: أَنْ يكونَ بدلًا من {أُوْلُو}. والثاني: أنه مبتدأٌ وما بعده خبرُه، والجملةُ خبرُ الأول.قوله: {في كتَاب الله} يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ ب {أَوْلَى}؛ لأنَّ أَفْعَلَ التفضيل يعملُ في الظرف. ويجوزُ أَنْ تتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنها حالٌ من الضمير في {أَوْلَى} والعاملُ فيها {أَوْلَى} لأنها شبيهةٌ بالظرف. ولا جائزٌ أَنْ يكونَ حالًا منْ {أُوْلُو} للفَصْل بالخبر، ولأنَّه لا عاملَ فيها.قوله: {من المؤمنين} يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنها من الجارَّةُ للمفضول كهي في زيدٌ أفضلُ من عمروٍ المعنى: وأُولو الأرحام أَوْلَى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب. والثاني: أنَها للبيان جيْءَ بها بيانًا لأُوْلي الأرحام، فتتعلَّق بمحذوف أي: أعني. والمعنى: وأُولوا الأرحام من المؤمنين أَوْلَى بالإرث من الأجانب.قوله: {إلاَّ أَن تفعلوا} هذا استثناءٌ منْ غير الجنس، وهو مستثنىً منْ معنى الكلام وفحواه، إذ التقديرُ: أُولو الأرحام بعضُهم أَوْلَى ببعض في الإرث وغيره، لكن إذا فَعَلْتُمْ مع غيرهم منْ أوليائكم خيرًا كان لكم ذلك. وعُدّي {تَفْعَلوا} بإلى لتضمُّنه معنى تَدْخُلوا.قوله: {وَإذْ أَخَذْنَا} يجوزُ فيه وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ منصوبًا ب اذكر. أي: واذْكُرْ إذ أَخَذْنا. والثاني: أَنْ يكونَ معطوفًا على محلّ {في الكتاب} فيعملَ فيه {مَسْطُورًا} أي: كان هذا الحكمُ مَسْطورًا في الكتاب ووقت أَخْذنا.قوله: {ميثاقًا غليظًا} هو الأولُ، وإنما كُرّر لزيادة صفته وإيذانًا بتوكيده.قوله: {لّيَسْأَلَ} فيها وجهان، أحدُهما: أنها لامُ كي أي: أَخَذْنا ميثاقَهم ليَسْأل المؤمنين عن صدقهم، والكافرين عن تكذيبهم، فاستغنى عن الثاني بذكْر مُسَبّبه وهو قولُه: {وأَعدَّ}. والثاني: أنها للعاقبة أي: أَخَذَ الميثاقَ على الأنبياء ليصيرَ الأمرُ إلى كذا. ومفعولُ {صدقهم} محذوفٌ أي: صدْقهم عهدَهم. ويجوز أن يكون {صدْقهم} في معنى تَصْديقهم، ومفعولُه محذوفٌ أيضًا أي: عن تصديقهم الأنبياءَ.قوله: {وأَعَدَّ} يجوزُ فيه وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ معطوفًا على ما دَلَّ عليه {ليَسْألَ الصادقين}؛ إذ التقديرُ: فأثاب الصادقين وأعَدَّ للكافرين. والثاني: أنه معطوفٌ على {أَخَذْنا} لأنَّ المعنى: أنَّ اللَّهَ تعالى أكَّدَ على الأنبياء الدعوةَ إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعَدَّ للكافرين. وقيل: إنه قد حَذَفَ من الثاني ما أثبت مقابلَه في الأول، ومن الأول ما أثبتَ مقابلَه في الثاني. والتقدير: ليسألَ الصادقين عن صدْقهم فأثابهم، ويَسْألَ الكافرين عَمَّا أجابوا به رُسُلَهم، وأعَدَّ لهم عذابًا أليمًا. اهـ.
{وَإذْ أَخَذْنَا منَ النَّبيّينَ ميثَاقَهُمْ وَمنْكَ وَمنْ نُوحٍ وَإبْرَاهيمَ وَمُوسَى وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا منْهُمْ ميثَاقًا غَليظًا (7)}.أخذَ ميثاق النبيين وقتَ استخراج الذرية من صُلب آدم- فهو الميثاق الأول، وكذلك ميثاق الكلّ. ثم عند بَعْث كلّ رسول ونُبُوَّة كلّ نبيّ أخذ ميثاقة، وذلك على لسان جبريل عليه السلام، وقد استخلص الله سبحانه نبيَّنا عليه السلام، فأسمعه كلامَه- بلا واسطة- ليلةَ المعراج. وكذلك موسى عليه السلام-أخذ الميثاق منه بلا واسطة ولكن كان لنبينا- صلى الله عليه وسلم- زيادة حال؛ فقد كان له مع سماع الخطاب كشفُ الرؤية.ثم أخذ المواثيق من العُبَّاد بقلوبهم وأسرارهم بما يخصهم من خطابه، فلكلّ من الأنبياء والأَولياء والأكابر على ما يُؤهلهم له، قال صلى الله عليه وسلم: «لقد كان في الأمم مُحَدَّثون فإن يكن في أمتي فَعُمَر» وغيرُ عمر مشاركٌ لعمر في خواص كثيرة، وذلك شيء يتمُّ بينهم وبين ربّهم.{ليَسْأَلَ الصَّادقينَ عَنْ صدْقهمْ وَأَعَدَّ للْكَافرينَ عَذَابًا أَليمًا (8)}.يسألهم سؤال تشريفٍ لا سؤال تعنيف، وسؤال إيجابٍ لا سؤال عتاب. والصدقُ ألا يكون في أحوالكَ شَوْبٌ ولا في اعتقادك رَيْبٌ، ولا في أعمالك عَيْبٌ. ويقال من أمارات الصدق في المعاملة وجودُ الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق. والصدقُ في الأحوال تصفيتُها من غير مداخلة إعجاب.والصدق في الأقوال سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين الناس والتباعدُ عن التلبيس، وفيما بينك وبين الله بإدامة التبرّي من الحَوْل والقوة، ومواصلة الاستعانة، وحفظ العهود معه على الدوام.والصدق في التوكل عَدَمُ الانزعاج عند الفَقْد، وزوال الاستبشار بالوجود.والصدق في الأمر بالمعروف التحرُّز من قليل المداهنة وكثيرها، وألا تتركَ ذلك لفَزَعٍ أو لطَمَعٍ، وأن تَشْرَبَ مما تَسْفي، وتتصف بما تأمر، وتنهي نَفْسَك عما تَزْجُر.ويقال الصدق أن يهتدي إليكَ كلُّ أحد، ويكون عليك فيما تقول وتظهر اعتماد.ويقال الصدق ألا تجنحَ إلى التأويلات. اهـ.
|